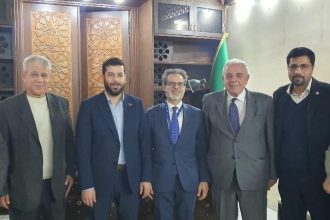الحرية- علي الرّاعي:
توزع الكاتبة السورية رواية زاهر شواغلها الإبداعية في منحيين.. الأول: النقد الأدبي، والثاني: الإبحار في عالم الشعر، وفيما بينهما ثمة مناخ لكتابة القصة القصيرة، ذات التكثيف الشعري أو (الأقصودة)، أو ما عُرفت به (القصة القصيرة جداً) التي تأخذ من الشعر مختلف مجازاته، ومن القصة جوهر الحكاية والحدث..
وها هي بعد سلسلة من القراءات النقدية تناولت خلالها عشرات الإصدارات لاسيما الشعرية منها للكثير من الكتاب السوريين، ومن أجيالٍ مختلفة.. تُصدر مجموعتها الشعرية عن دار دلمون الجديدة بدمشق، وبعنوانٍ لافت (عاريةٌ سيقانُ هذا المساء)..
“(…)
الغابةُ كلّها صارت رماداً,
ووحيدة هي في لظى الحريق..
تظّنهُ الدّفء يدغدغُ أوصالَها،
وما علمت أنّه نباحُ الرّيحِ
(…)”
وفي عالم الشعر، حيث تكون الكلمات أحياناً أقنعة تخفي أكثر مما تظهر، تأتي الشاعرة راوية زاهر لتزحزح، وفي أحيانٍ أخرى لتمزق هذه الأقنعة بحساسية مفرطة وجرأة نادرة.. ومجموعتها “عاريةٌ سيقان هذا المساء” تشبه غرفة عمليات مفتوحة على جراح الذات والوطن، حيث لا مكان للاختباء وراء البلاغة الفارغة أو التقنيات المتعالية.

فـ”العري” الذي يتصدر عنوان المجموعة ليس مجرد إيحاء جسدي، بل هو موقف وجودي ترفعُ الشاعرة شعاره في مواجهة عالمٍ مزيف.. ومن ثمّ فهو عري الروح من الأقنعة، وعري المشاعر من التبريرات، وعري اللغة من الزخارف.
في نص “ياليت” الذي يفتتح، نجد هذا العري بكل وضوح: “ياليتني أستطيع
أن
أخلع سوادي”..
إنها رغبة في التحرر من الحداد الداخلي، من السواد الذي يلتصق بالروح كجلد ثانٍ، كما أنّ هذا العري يتجلى أيضاً في اعترافاتها الهشة:
“كنت سأتخلص
من تجاعيد الكلمات،
وفواصل الزمن”.
فالشاعرة تدرك أن تجاعيد الروح أعمق من تجاعيد الوجه، وأن الزمن الداخلي أثقل من زمن الساعات.
تمثلُ النصوص الشاعرة زاهر معضلة الحنين الذي لا ينقطع. ففي نص “الضيعة” تصور قريتها كجنة مفقودة:
“على طرقاتك القديمة،
مشينا
ونمشي مدججين
بالحبّ والحنين”.
لكن هذا الحنين ليس مجرد نوستالجيا رومانسية، بل هو وعي بالخسارة والانفصال. فالقريّة “السارحة مع قطعان الغيم” لم تعد سوى صورة في الذاكرة، والواقع أن “الرحيل عنوان أزليٌّ للأصياف والمرابع”.. في نصٍ آخر تتحول هذه المفارقة إلى صراع مع الزمن
“أيّها
الرّيف النّائم
على زند المستحيل”.
الريف هنا ليس مجرد مكان، بل هو زمن ميتافيزيقي، حلم بماضٍ لم يعد ممكناً، وربما لم يكن موجوداً أصلاً.
وفي عالمٍ تتحكم فيه قوى أكبر من الإنسان، تطرح زاهر أشكالاً غير تقليدية للمقاومة., في نصها عن الريح، نجدُ مفارقة الصمت في مواجهة العاصفة:
“وصامتون نحن كمقبرة..
وكأن في رؤوسنا
تجأر آلاف الأصوات
من بنات آوى!!”.
فالصمت هنا ليس انهزاماً، بل هو شكل من أشكال المقاومة السلبية، مثل صمت المقابر الذي يخفي تحت سطحه عوالم من الصرخات.. وفي نص “جزيرة الملح” تتحول المقاومة إلى رقصة وجودية: “ارقصْ بوقار؛ فالخلاخل ترنُّ دون توقّف”. الرقص هنا ليس ترفيهاً، بل هو فعل مقاومة في عالم تحول إلى “جزيرةٍ من الملح وعشائرَ من البزّاق”. إنه رقص المنسيين، رقص من يفقدون كل شيء إلا كرامة الانهيار.
تبدعُ زاهر في استخدام السخرية السوداء كسلاحٍ لمواجهة اللامعقول. وفي نص “أبي فوق الشجرة” تقدم نقداً لاذعاً للانشغال بقضايا هامشية في عالم يعج بالمآسي الكبرى.. تسخر من انشغال الناس بـ”قضية البكيني في فرنسا” على سبيل المثال، بينما الأوطان “مدلاة على مشنقة الريح”.. هذه السخرية تصل ذروتها في نص “جغرافيا” حيث تعدد “الحريات” الممنوحة في جغرافيا مأساوية: إنها سخرية مريرة من واقع حيث أصبح الموت والبكاء هما الحرية الوحيدة المتاحة.
” ارسم لي في ظلال هذا الفراغ أرجوحةً،
وبعض الدمى،
علبة سكاكر،
وخيوطاً عالية تزاحم اتساع المدى..
اترك لي علبةَ ألوان
لأرسم كوخاً في مكانٍ قصي،
يزنرهُ العشبُ، ويلفُّ أكتافَهُ شجرُ الحور..
(…)”
تمتلك زاهر لغة شعرية متميزة، تجمع بين الانزياح الجريء والتجسيد المحكم.. فهي تصف الريف بأنه “يرتدي سترة كبار السن، ويتكوّر بجلبابك الخاكي”، وتشبّه الحياة بـ”فم حيوانٍ متوحشٍ شرهٍ لابتلاع أبطال الحكايات”.. هذه الانزياحات لا تهدف للإبهار فقط، بل هي جزء من رؤيتها للعالم.. فحين تصف الليل بأنه يعود “تحت شرفةِ قمرٍ كابيّ اللون قدسيّ الحضور”، فإنها تخلق عالماً شعرياً مكتملاً، حيث يمتزج الجمال بالألم، والمقدس بالكئيب.
كما تمثلُ نصوص زاهر نموذجاً لتشابك هويتي الأنثى والوطن. فمعاناتها كأنثى لا تنفصل عن معاناتها كجزء من وطن محاط بالأعداء من جهاته الست. وفي نص “ياليت” نجد الحنين الشخصي ممزوجاً بالحنين الجماعي: “كنت سأكتب شعراً عن الحب والعاشقين وعن وطن بلون القمح والمرمر”.. هذا التشابك يظهر بوضوح في نص “الضيعة” حيث تتحول القرية إلى أنثى، والأنثى إلى وطن: “قريتي
السارحة مع قطعان الغيم”. إنها لا تفصل بين تحررها كأنثى وتحرر وطنها من قيوده.
” غريبٌ أنتَ كليلٍ،
يتجوّلُ وحدَه في مدنٍ عمياء،
يسائلُ خيطَ الفجر:
كيف تنامُ الذكرى البلهاء في أحشاءِ العتمِ؟
ليردَّ بكاملِ رعشته:
حتى لو مُتَ، أوعشتَ،
أوكنتَ كناقوسٍ حجريّ تلطمك أمواجُ البحر،
أو ذبتَ بعيداً في الصحراء كتمثالٍ من ملح؛
سيعودُ الصّبحُ كماء المطر نقياً؛
كالسحبِ.”
ما تقدمه راوية زاهر في مجموعتها “عاريةٌ سيقان هذا المساء” هو شعرية الرقة، أو ربما شعرية الهشاشة. وهنا ليست هشاشة الضعف، بل هشاشة الصدق.
إنها تكتب من منطقة الخطر، حيث تتعرض الذات واللغة والوطن للتمزق في آن واحد.. هذه النصوص ليست مجرد تعبير عن ألم فردي، بل هي شهادة على عصر بأكمله.. شهادة ترفع صوتها عالياً رغم كل محاولات إسكاتها: “انفض غبارك أيها الزّمن.. غابت فيك ملامحنا تاهت فيك مراثينا”.. كلُّ ذلك في مساءات عاريةٌ سيقانها.