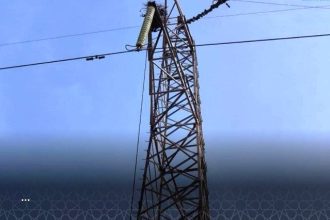وصلت الصحفية البريطانية بريجيت كنان إلى سوريا عام 1993، بعد تعيين زوجها دبلوماسياً فيها. وكما حدث قبل أكثر من 120 عاماً مع إيزابيل زوجة القنصل البريطاني ريتشارد بيرتون، سرعان ما وقعت كنان في غرام مدينة دمشق. وعلى ما تقوله، بدأت قصة عشقها للمدينة القديمة عندما دخلت لأول مرة إلى أحد البيوت الدمشقية الكبيرة “بيت المجلّد”. ومن ثم أثمرت هذه التجربة كتابها الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب بعنوان “دمشق القديمة وكنوزها الدفينة”، الذي نقله إلى العربية المترجم محمد علام خضر بأمانة ومحبة تعكس ما أرادته المؤلفة لقرّاء لغتها الأصلية.
مُناسبة الحديث عن الكتاب الذي أصبح مرجعيةً للباحثين في التراث المعماري، استحضار جهود المترجمين السوريين في مختلف المجالات، والذين تغيب أسماؤهم عن المشهد الثقافي، لأسباب عدة، رغم إبداعاتهم التي كثيراً ما تجاوزت حدود المحليّة، وهنا يُحسب للندوة الوطنية للترجمة، والتي اختُتمت فعالياتها اليوم تحت عنوان “الترجمة في التقانات الحديثة”، بتنظيمٍ من الهيئة العامة السورية للكتاب ومجموعة جهات ثقافية وأكاديمية، إتاحة الفرصة لعددٍ منهم للتعريف بما توصلت إليه دراساتهم وأبحاثهم في عوالم الترجمة، وهو ما يصعب التطرق إليه بتفصيل في هذه المقالة.
+ الأضرار التي لحقت بالبلاد خلال السنوات الماضية، حرمت الجامعات والمؤسسات من أبسط مقومات العصر الرقمي كالكهرباء وشبكة الإنترنت المستقرة، ما يجعل أي حديث عن الذكاء الاصطناعي أشبه بضرب من الخيال
تحديات البنية التحتية
من بين الدراسات والأصوات التي برزت في الندوة، تحدث الدكتور عبد النبي اصطيف أستاذ الأدب المقارن والنقد الحديث والترجمة في جامعة دمشق، وعضو الفريق المؤسس للمعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية، عما يشهده ميدان الترجمة من تحولاتٍ هائلة بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، غير أن هذه الإنجازات المستمرة تصطدم بجدار الواقع الصعب في سوريا، كونها تواجه تحديات بنيوية عميقة تعوق الاستفادة من هذه الثورة التقنية برأيه. وفي مقدمتها تأتي أزمة البنية التحتية، فالأضرار التي لحقت بالبلاد خلال السنوات الماضية، حرمت الجامعات والمؤسسات من أبسط مقومات العصر الرقمي كالكهرباء وشبكة الإنترنت المستقرة، ما يجعل أي حديث عن الذكاء الاصطناعي أشبه بضرب من الخيال.
وذهب اصطيف إلى أن تكلفة تبني التقنيات الحديثة تفوق قدرة المؤسسات التعليمية، التي لا تستطيع حتى مواكبة حركة النشر العالمية بالتحول من الكتاب الورقي إلى الاشتراك الرقمي مع دور النشر الكبيرة، والتي تقوم في أماكن أخرى برفد الجامعات بأحدث ما لديها من إصدارات. كما يضاف إلى ذلك، الحاجة المُلحة لتأهيل الكوادر وطلاب العلم لمواجهة هذا التحول.
وفي السياق ذاته، أشار اصطيف إلى أنه لا يمكن إغفال إشكالية العامية العربية التي تُشتت الجهد التنسيقي المشترك بين الدول العربية، وتفرض على حقل الترجمة التعامل مع تعددية اللهجات بدل الاحتكام إلى اللغة الفصحى كركيزة موحدة. وعلى حدّ تعبيره “نحن لا ننتج المعرفة، ومن ثم لا نتدخل في التعبير عن مخرجاتها، لذلك نحن مضطرون لترجمتها إلى لغتنا، فضلاً عن حاجتنا إلى تطوير لغتنا الأم، لمواكبة ما يطرأ في ميدان المصطلحات، وتعميق معرفة المترجم بثقافة واختصاص كلتا اللغتين”.
بين الطلبة والمحترفين
بدوره الدكتور عدنان عزوز، عميد كلية الآداب ورئيس قسم اللغة الإنكليزية في جامعة قاسيون الخاصة، قدّم بحثاً حاول فيه الإجابة عن سؤال يفرض نفسه على المترجمين اليوم “الذكاء الاصطناعي في عالم الترجمة: صديق أم عدو؟”، بالاعتماد على التجارب، التي أثبتت، والكلام له، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مساعداً قوياً للطلبة، خاصة في تصحيح الأخطاء اللغوية وتقديم أنماط ترجمة مختلفة بالاعتماد على هندسة الأوامر (Prompting). وعلى سبيل المثال، بيّنت دراسة أن الطلاب الذين تدربوا على استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للتدقيق والتصحيح وليس للاعتماد المطلق، حققوا نتائج أفضل بنسبة 70% من أقرانهم في التعليم التقليدي، لكن الخطر الأكبر يكمن في الاعتماد المفرط، الذي يهدد بتهميش المهارات اللغوية العميقة اللازمة لإتقان الترجمة وفهم الثقافات.
+ الذكاء الاصطناعي ليس عدواً ولا بديلاً كاملاً، بل هو أداة يجب استخدامها بذكاء وتوظيفها ضمن مناهج تعليم الترجمة لضمان الحفاظ على العنصر البشري ومهاراته العميقة
أما بالنسبة للمترجمين المحترفين، فبيّن عزوز أنّ الذكاء الاصطناعي أدى إلى تحول في الأدوار من “مترجم” إلى “مدقق لغوي”، ما زاد من سرعة وجودة العمل وتوسيع نطاقه، وإن كانت أهم إشكاليات الذكاء الاصطناعي تظهر في أخطاء المعنى المتعلقة بفهم التعابير الثقافية والأمثال والتعقيدات القانونية، حيث لم يصل الذكاء الاصطناعي بعد إلى المقدرة على فهم هذه الدقائق. لكن ومع ذلك، هناك تخوفات حقيقية من فقدان الوظائف وتراجع الأجور، حيث أظهرت الإحصاءات الأمريكية انخفاضاً ملحوظاً في عدد الوظائف والأجور للمترجمين منذ عام 2016.
أيضاً شرح عزوز مسألة المسؤولية القانونية والأخلاقية المتعلقة بأخطاء الترجمة الآلية، بالإضافة إلى تهديد الخصوصية التي يفرضها تخزين النصوص الإلكتروني، ليؤكد في المحصلة، أن الذكاء الاصطناعي ليس عدواً ولا بديلاً كاملاً، بل هو أداة يجب استخدامها بذكاء وتوظيفها ضمن مناهج تعليم الترجمة لضمان الحفاظ على العنصر البشري ومهاراته العميقة.
ضمان الجودة
في حين شرحت هلا دقوري، وهي مترجمة فورية وتحريرية ومُحلّفة سورية، عن الفرص والتوجهات المستقبلية في عوالم الترجمة في العصر الرقمي، مشيرة إلى أن أنظمة الترجمة الآلية تُوفر السرعة وقابلية التوسع والاتساق، ما يجعلها أداة لا غنى عنها في الترجمات الروتينية والمتكررة لكنّ المترجم البشري يظل متفوقاً، وله دور محوري في المجالات التي تتطلب فهماً عميقاً وحساسية ثقافية، كالترجمة الأدبية والقانونية والطبية. ووفقاً لتجربة عرضتها خلال الندوة، فشل الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنوع اللغوي والإبداع البلاغي، والقدرة على معايشة المشاعر وفهم الكلمات العاطفية والمجازية بدقة.
وفي نفس الموضوع، وجدت دقوري أنّ دور المترجم المستقبلي سيتجه نحو الإثراء، بعيداً عما يتردد عن استبدال المترجم البشري، حيث يسمح الذكاء الاصطناعي للمترجمين بالتحرر من الأعمال الرتيبة والتركيز على المحتوى الإبداعي وضمان الجودة، وهي الكلمة المفتاحية في هذا العصر، حتى إنّ الطلب سيزداد على تحرير ما بعد الترجمة (Post-Editing)، ما يعزز دور المترجم كـ “مدقق ومُثْرٍ” لنتائج الآلة. مضيفةً أن هذا الدور الجديد يتطلب مجموعة من المهارات المزدوجة، أولها الوعي الثقافي واللغوي العميق لضمان دقة الترجمة ومراعاة الحساسيات الثقافية، ومن ثم المهارات التقنية لاستخدام أدوات الترجمة بفعالية.
كذلك لفتت دقوري إلى أهمية مناقشة القضايا الأخلاقية في الترجمة الآلية، ولا سيما ما يتعلق بخصوصية البيانات، وحقوق النشر، وتحديد المسؤولية عند فشل الترجمة الآلية، إضافة إلى مواجهة التحيزات الثقافية والجندرية التي قد تتسلل إلى مخرجات النماذج. وعلى ما تراه، فالمستقبل يتجه نحو الترجمات الهجينة التي تدمج خبرة البشر بقدرات الآلة، مع التركيز على التكيف الإبداعي والإثراء الدلالي من قبل المترجمين.
الحرية – لبنى شاكر
تصوير: حسن خليل