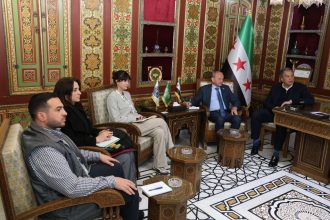الحرية- جواد ديوب:
استوقفتني صورةٌ نادرةٌ لـ”فوجُ كشّاف دمشق في زيارةٍ لمدينة دير الزور عام 1950″. لا أعرف كيف تداعت الأخيلة في قلبي، وتذكرت موال الراحل فؤاد غازي وهو يصدح:
“حلو يا الّلي القمر لولاك ما يتمّ/
هجرتني وتركت بالدار ميتم/
وكْ دجلة والفرا وسيحون ميتُم/
ما وازوا ربع دمعي ع الحباب”…
ردّدت الموال وعلق ملحُ الدمع على جفوني، ربما لأن في تلك الصورة جمالاً موجِعاً، فمنظر الفرات والجسر المعلّق ووجوه الفتيان الضاحكة تشقُّ القلب وتفطِر الروح.

أيقونات الذاكرة الهاربة!
يبدو أن للصور الفوتوغرافية منطقها الخاص وحكاياتها الفريدة، ورغم أن ما نراه هو لقطة واحدة تحكي حكاية أو تختزل سيرورةً زمنية وتسجنها في لحظة لا نعرف ما قبلها وما بعدها… لكنها أي الصورة/اللقطة تصبح الزناد الذي يقدحُ شرارةَ الخيال، كأنّ الصورَ هي أيقوناتُ الذاكرة الهاربة التي تجدُ عزاءَها في أنها بمقابل خسرانها للزمن؛ إنما احتفظتْ بظلاله البيضاء والسوداء ها هنا كحقيقةٍ ثابتة!
إذاً نحنُ مجرد علبةٍ من الصور وباقة من الذكريات المجففة! صورٌ هنا، صورٌ هناك، في الألبومات المحفوظة بعناية في درج أفراحنا وخيباتنا، صورٌ على الحائط في غرفة النوم، وغرفة الضيوف، وعند الأصدقاء القدامى، صورٌ بالأبيض والأسود، صور ملونة، وأخرى مسحوبٌ لونُها كالمصابة بالصدمة، و”نيغاتيفاتٌ” مشلوحةٌ ومنسيةٌ في السقيفة… واليوم مع جنون الذكاء الاصطناعي أصبحنا مجرد مئاتٍ من “اللحظاتِ الديجتالية” التي يمكن لنا تحريكها وتحريفها كأننا نتحايل ونضحك على الزمن الجبار الذي لا يهزم.
لكن لماذا يحتفظ العشاق مثلاً بصور أحبّتهم كما هي دون ذاك التزوير الديجتاليّ؟ ألهذه الدرجة تخونهم الذاكرة في استرجاع لون عيونهم وعدد شاماتهم وعرض الحاجبين وشكل الأنف والمبسم؟ أم هو الخوف من تحوّلٍ مفاجئ يغيّر من السيل التلقائي للذكريات التي ألفناها، الخوف من أن تتمزّق الصورة المعتادة والمألوفة فلا يعود بإمكاننا تقطيبُ الذكريات الحميمة؟!
“بروفايلاتٌ” و”لايكات”!
لكن الاحتفاظ بالصور سواء المطبوعة القديمة أو الإلكترونية الحديثة ينجَدِلُ، باعتقادي، مع تلك الرغبة العميقة في أنْ نُعرَفَ، أنْ يشاهدنا الآخرون، أنْ يتركَ وجودنا المصوَّرُ أثراً ما في خيال الآخرين ولو كان أثراً بحجم “لايك” أزرق!
أذكر أنني وضعتُ صورةَ “بروفايل” جديدة على صفحة الفيسبوك، فتتالت “اللايكات” والتعليقات والقلوب الملّونة وباقات الورد المنتقاة بلباقة، وكلّها غمرتني وجعلتني أسبح في غيمة أفكار وتخييلاتٍ ممتعة.
فكّرت بدايةً: لماذا فعلاً وضعتُ صورةً جديدة؟ هل مِن رغبة في التغيير أمْ من رغبةٍ في تلقّي الإطراء والإحساس بأنني كائن حيٌّ له تأثيرٌ ولو صغيرٌ على مَن حوله؟ أم مِن حاجة إلى تلقّي المحبّة؟
ثم فكّرت بشيءِ من السلبية: هل تضعُ كميّة اللايكات الإنسانَ في “خانة الشخص المحبوب”؟ أم هي ليست أكثر من مجاملة اجتماعية تشبه أحياناً قولنا لأحدهم “صباح الخير” فيما نخفي وراءها سيلاً من حساسياتٍ متراكمةٍ مثل فيضانٍ محبوسٍ خلف سدّ المجاملات؟ ما معنى أن يعرِضَ المرءُ نفسه على شكل “صورة/بورتريه”؟ أيّ هذيان هو هذا المتجسّد على شكل عينين وأنفٍ وأذنين وشفتين… وهو في الحقيقة ليس إلّا قطعةً من شُهبِ الزمنِ وَمَضَتْ وانتهتْ!
تذكّرت جدتي غزالة -رحمها الله- حين كانت تقول لي في مراهقتي: “يا ابني لا تطلّع بالمراية كتير… بعدين بتجنّ”!
يا إلهي يا جدتي “أم خليفة” أيُّ جملةٍ سحريّةٍ هي هذه التي تستبصرُ كيفَ يتحوّلُ النرجسيُّ إلى مجنونٍ عظمة؟ أي فَكاهةٍ مُرّة لم أدركها حين كنتُ أُطلِقُ ضحكاتي للريح وأردّ عليكِ: “إنْ كانَ الجنون هكذا؛ فما أحلاه”!
وفكّرتُ كيف حوّلتنا وسائل التواصل الاجتماعي إلى شخصياتٍ بلاستيكيةٍ بلا طعم ولا لون ولا رائحة… وفوقَ ذلك إلى كائناتٍ مغرورةٍ متعالية!
ربما لهذا قال عالم الاجتماع الألماني والتر بنيامين: “إن ثورة القرن التاسع عشر الحقيقية كانت مع اختراع الفوتوغرافيا، فعلى مدار التاريخ كان الناس بغير وجوه، ثم بغتةً صار للناس وجه! كانت الصورُ الفوتوغرافية الأولى توضعُ في علبِ المجوهرات محاطة بالرسائل الأكثر سريةً! الآن بات ممكناً أن يراكَ ثلاثون، أربعون، خمسون مليون إنسان، صار لكَ وجود؛ أنتَ شخصٌ ما… لكنْ لا يهم كم هو عابرٌ هذا الشخص، كم هو مؤقتٌ هذا الوجود.”!