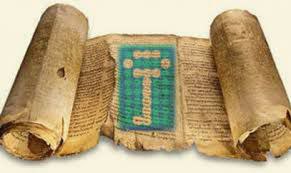الحرية- رنا بغدان:
يُعـد علم “التعمية” أحد الشواهد على شـمولية التراث العربي والإسلامي وموسوعيته المعـرفـية, فقد حفظت المخطوطات العربية علم “التعمية واستخراجُ المُعمَّى” أو “التشفير وكَسْرُ الشِفرة”, واسـتـخـدم نـاسـخـوها هذا العلم فـي تدوين تـاريخ نـسـخ المخـطـوطـات قـبل مـعـرفـتـهم للأرقـام; فأرَّخـوا بـالـعـبـارة “حـسـاب الجُـمَّل” كـمـا أرَّخـوا أيـضـاً بـالـكـسـور وهو مـا يُـعـرَف بـ”الـتـأريخ الـكـنـائي”.
وقد لجـأ الـعـرب مـنـذ الجـاهـلـيـة إلى الـتـرمـيـز والألـغـاز والـتـوريـة.. بغرض إخفاء مقاصدهم وأهدافهم والحـفـاظ عـلى سِريَّـة الـرسائـل الخاصـة بـهم.. و استعملوا “التعمية” في التراث العربي في العصور الإسلامية الأولى ومع اتساع أطراف الـدولة الإسلامية كانت الحـاجة ماسة للـتعرف على طرائق تـفي بإخفاء أغراضهم فاسـتـعـمـلـوا ألـفاظاً عديدة نذكر منها “الـتـرجـمـة, المترجم، المبهم، المرموز، والكتابة الباطنة..”, لـلـتـعـبـيـر عن هـذا الـعـلم بـشـقـيه “الـتـعـمـيـة- التشفير” و”استخراج المعمَّى”. وكانوا السبّاقين إلى تدوينه وإرساء أصوله وصوغ مبادئه وقواعده ووضع مصطلحاته وابتداع منهجياته وعالجوا سبل استخراجه و”خوارزمياته”.. كما أسهم استعمالها في الحضارات العديدة في فك رموز عدد من اللغات القديمة مثل الهيروغليفية والمسمارية.
لكن تدوين “التعمية” في مؤلَّف يجمع أصولها وقواعدها وسبل استخراجها لم يتحقق إلّا على يد الفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي (ت: 260هـ – 874م) في مصنفه “رسالة في استخراج المعمّى”، التي أفاد منها كلُّ مَن جاء بعده من العرب وغيرهم فكان رائداً في تأليف أقدم مدونة وصلت إلينا كما كان أول من عرف مبدأ استعمال الكلمة المحتملة، وأول من فرق بين طريقتي التعمية بالبعثرة والاستبدال. . بل قـد يـكـون الأمـر أســبق من ذلـك أيـضـاً, إذ ذَكَــرَ الـزبــيــديّ (ت٣٧٩هـ) أنَّ الخـلــيل بـن أحـمــد الــفـراهــيـدي (ت١٧٠هـ) له كـتـاب فـي المـعـمَّـى.
وهناك من اشتهر بخبرته وكثرة مؤلفاته في هذا العلم، مثل علي بن محمد بن الدريهم (ت 762 هـ / 1361م) صاحب كتب: مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز وإيضاح المبهم في حلّ المترجم ومختصر المبهم في حل المترجم، ونظم القواعد في المترجم وضوابطه.. وكان أول من عرض طريقة التعمية باستعمال شبكة بسيطة.
“التعمية واستخراج المعمى” هما مصطلحان مرتبطان بعلم التعمية, فـ”التعمية- التشفير” هي عملية تحويل النص العادي إلى نص مشفر (معمى) لحمايته من الفهم غير المصرّح به, بينما “استخراج المعمى- فك التشفير” هو عملية استعادة النص الأصلي من النص المشفر من دون معرفة مفتاح التعمية أو طريقة التعمية الأصلية.
وقد أسهمت “التعمية” في تطوير الأساليب اللغوية والبلاغية، حيث استخدمت كأداة لإنشاء نصوص مبهمة أو ذات معانٍ متعددة, معتمدة على طريقتين أساسيتين هما “تــعـمـيـة المعـاني بـالـتـوريـة” وتـعـتـمـد عـلى فـطـنـة المتـراسلين وخبـرتهم وثقافـتهم وهي أقرب إلى العـمل الأدبي أو البديعـي, و”الـتـعــمـيـة بمــعـالجـة الحـروف” وتـكـون بـاتـبـاع طـرق تـلـزمُ قـواعـدَ مـحـددةً, ويمكن تقسيمها إلى أربع طرق رئيسة هي “التعـمية بـالقلب”, “الـتـعـميـة بـالإعـاضة أو الـتـبديل”, “الـتعـميـة بزيـادة حروف أو حـذفها”, و”الـتـعمـيـة المـركـبة”.
يذكر أن التعمية لم تحظَ باهتمام الباحثين المعاصرين حتى أماط اللثام عن مخطوطاتها ونهض بالتحقيق عنها ودراستها ثلاثةُ باحثين: (د. محمد مراياتي، ود.محمد حسان الطيان، ود. يحيى مير علم) بمساعدة الأستاذ مروان البواب، وصدرت في جزأين عن مجمع اللغة العربية بدمشق، بعنوان “علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب”؛ بتقديم خطَّه رئيس المجمع وقتئذ المرحوم الدكتور شاكر الفحام أولهما عام 1987م وثانيهما عام 1997م.